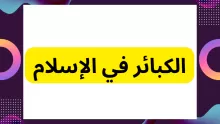أنواع وتاريخ الكفر في الاسلام وعقوبته

ما هو تعريف الكفر في الإسلام؟
معنى الكفر لغة واصطلاحًا:
- لغةً: الكفر في اللغة العربية يعني الستر والتغطية. ومنه سُمِّي الزرّاع "كُفّارًا" لأنهم يغطون البذور بالتراب، كما قال الله تعالى:
﴿كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ﴾ [الحديد: 20] أي الزرّاع.
- اصطلاحًا شرعيًا: الكفر هو جحود ما أوجبه الله من الإيمان به وبرسله وكتبه وشرائعه، أو إنكار ما عُلم من الدين بالضرورة، أو الإعراض عن ذلك استكبارًا أو استهزاءً أو شكًا.
متى يكون الإنسان كافر؟
يكون الإنسان كافرًا في الإسلام إذا تحققت فيه شروط الكفر وانتفت عنه الموانع، وذلك في حال جَحَد أو أنكر أو رفض ما أوجب الله الإيمان به أو فعل ما يخرج من الملة، والحالات التي يكون فيها الإنسان كافرًا، ما يلي:
1. الكفر الاعتقادي (الأكبر)
- جحود أركان الإيمان أو الإسلام أو بعضها.
- إنكار ما عُلم من الدين بالضرورة (مثل وجوب الصلاة أو تحريم الزنا) مع العلم بحكمه.
- الإعراض عن الدين بالكلية، فلا يتعلمه ولا يعمل به.
- الاستكبار عن طاعة الله بعد معرفة الحق، مثل كفر إبليس.
- الاستهزاء بالله أو رسوله أو القرآن.
2. الكفر العملي المخرج من الملة
- القيام بفعل يدل على الردة، مثل:
- سبّ الله أو الرسول ﷺ.
- السجود لصنم أو عبادة غير الله.
- الاستهزاء بالشريعة أو أحكامها.
الشروط الواجب تحققها قبل الحكم بالكفر
- العلم: أن يكون عالمًا بأن ما فعله أو قاله كفر.
- القصد: أن يقصد المعنى الكفري، لا أن يكون سبق لسان أو خطأ.
- الاختيار: أن يكون مختارًا غير مكره.
- انعدام الشبهة: ألا يكون لديه تأويل معتبر أو جهل يعذر به.
الموانع التي تمنع الحكم بالكفر
- الجهل المعتبر شرعًا.
- الإكراه.
- الخطأ أو السهو.
- التأويل المحتمل.
أنواع الكفر في الإسلام
- كفر الجحود: إنكار الحق بعد معرفته.
- كفر الإباء والاستكبار: مثل كفر إبليس، يعرف الحق لكنه يرفضه تكبرًا.
- كفر النفاق: إظهار الإسلام وإبطان الكفر.
- كفر الإعراض: ترك الالتفات إلى الإيمان وعدم الاهتمام به.
- كفر الشك: التردد في التصديق.
أولًا: الكفر الأكبر
هو الكفر المخرج من الملة، وصاحبه إذا مات عليه فهو مخلّد في النار، ويُسمّى أيضًا الكفر الاعتقادي، وأنواعه كما ذكرها العلماء:
- كفر الجحود والتكذيب: إنكار ما جاء به الرسول ﷺ، أو تكذيب القرآن والسنة، مثال: إنكار وجوب الصلاة أو تحريم الزنا مع العلم بثبوته.
- كفر الإباء والاستكبار: معرفة الحق ورفضه تكبرًا، مثال: كفر إبليس بسجود آدم: ﴿أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: 34]
- كفر النفاق: إظهار الإسلام وإبطان الكفر في القلب، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ [النساء: 145]
- كفر الإعراض: الإعراض الكلي عن الدين، وعدم التعلم أو العمل به.
- كفر الشك أو الظن: التردد وعدم اليقين بما أوجب الله الإيمان به.
ثانيًا: الكفر الأصغر
هو كفر عملي لا يخرج من الملة، لكنه من كبائر الذنوب، وصاحبه تحت مشيئة الله يوم القيامة.، سُمّي "أصغر" لأنه لا يصل إلى حد الكفر الاعتقادي، لكنه يشترك معه في الاسم لوجود مشابهة في المعصية، ومن أمثلة على الكفر الأصغر:
1. كفر النعمة:
- جحود فضل الله، ونسب النعمة لغيره. ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً ... فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ﴾ [النحل: 112]
2. الطعن في الأنساب والنياحة على الميت
- كما قال النبي ﷺ: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت» (رواه مسلم).
3. قتال المسلم لأخيه المسلم
- قال النبي ﷺ: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» (رواه البخاري ومسلم) (المقصود هنا الكفر الأصغر، إلا إذا استحل ذلك).
شروط الكفر في الإسلام
لعلماء ذكروا أن الحكم على شخص بالكفر له ضوابط دقيقة، حتى لا يُتسرع في التكفير. ومن أبرز الشروط التي لا بد من تحققها قبل اعتبار الفعل أو القول كفرًا على صاحبه:
- العلم: أن يكون الشخص عالِمًا بأن ما قاله أو فعله مخالف للإسلام ومخرج من الملة، وليس جاهلًا به. مثال: من نشأ في بيئة لا تعرف الإسلام قد يُعذر بجهله حتى تُقام عليه الحجة.
- القصد والإرادة: أن يقصد الفعل أو القول الكفري بإرادته، لا عن طريق الخطأ أو السهو أو الإكراه. قال الله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾ [النحل: 106]
- الاختيار: أن يكون مختارًا غير مكره، فالمكره لا يُحكم بكفره إذا كان قلبه مؤمنًا.
- النية: أن يكون الفعل صادرًا عن نية حقيقية للكفر، لا مجرد مزاح أو كلام لا يقصد معناه، وإن كان المزاح بالكفر أمرًا خطيرًا وقد يقع فيه الكفر إذا كان استهزاءً بالدين. قال تعالى: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ • لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [التوبة: 65-66]
- انعدام الشبهة: ألا يكون عنده شبهة معتبرة تبرر فعله أو قوله، فإذا كان عنده فهم خاطئ أو تأويل محتمل يُزال الشبهة أولًا.
العلماء أكدوا أن التكفير حكم شرعي لا يجوز أن يقوم به أي شخص، بل هو من اختصاص القضاة والعلماء المؤهلين بعد التحقق من جميع الشروط وانتفاء جميع الموانع.
تاريخ الكفر في الاسلام
تاريخ الكفر في الإسلام" يمكن تناوله من منظورين:
- منظور لغوي وشرعي: الكفر في اللغة هو الستر أو التغطية، وفي الشرع هو جحود ما أوجب الله الإيمان به.
- منظور تاريخي: يتناول المراحل التي ظهر فيها الكفر ومواجهته منذ بعثة النبي ﷺ وحتى الفترات اللاحقة في التاريخ الإسلامي.
1. في عهد النبي ﷺ
- مع بداية الدعوة في مكة، واجه الرسول ﷺ معارضة من قريش الذين تمسكوا بعبادة الأصنام ورفضوا التوحيد، وهو ما مثّل أول مواجهة بين الإسلام والكفر.
- القرآن الكريم وثّق أشكال الكفر آنذاك: كفر الجحود (إنكار الحق مع العلم به)، وكفر الإعراض (ترك الاستماع والاتباع).
- بعد الهجرة إلى المدينة، ظهرت أشكال أخرى مثل كفر النفاق (إظهار الإسلام وإبطان الكفر).
2. بعد الفتح الإسلامي
- توسعت الفتوحات وواجه المسلمون أقوامًا يدينون بديانات مختلفة أو لا يدينون بدين، فكان هناك تعامل وفق الشريعة: الجزية، أو الدخول في الإسلام، أو القتال عند العداء.
- ظهر أيضًا الردة بعد وفاة النبي ﷺ، حين ارتد بعض العرب عن الإسلام أو امتنعوا عن الزكاة، وواجههم أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حروب الردة.
3. في العصور الأموية والعباسية
- استُخدم مفهوم الكفر أحيانًا في الخلافات السياسية أو المذهبية بين الفرق، فاتهمت بعض الفرق الأخرى بالكفر لأسباب عقدية أو سياسية.
- ظهرت تيارات فكرية وفلسفية واجهت الإسلام، منها الزنادقة والملاحدة، وكان للدولة موقف حازم منهم.
4. في العصور المتأخرة
- ظل مصطلح الكفر في الفقه مرتبطًا بالأحكام الشرعية، لكن مع ظهور الاستعمار الأوروبي في العالم الإسلامي، اعتبر كثير من العلماء مقاومة المحتل جزءًا من الدفاع عن الدين.
- في العصر الحديث، وُجهت تهمة الكفر أحيانًا في الصراعات الفكرية والسياسية، وهو أمر حذّر العلماء من التسرع فيه.
حكم الكفر في الاسلام
أولًا: من حيث العقيدة
- الكفر هو أعظم الذنوب وأكبر الجرائم في الشريعة، لأنه إنكار لحق الله في العبادة أو جحود لما أوجبه.
- من مات على الكفر فهو مخلّد في النار، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [البقرة: 161]
ثانيًا: من حيث الحكم الشرعي في الدنيا
- من وقع في الكفر بعد إقامة الحجة عليه وثبوت الشروط وانتفاء الموانع، يُحكم بردته عن الإسلام.
- المرتد يُدعى للتوبة، فإن تاب قبلت توبته، وإلا عومل بأحكام المرتدين التي بيّنها الفقهاء.
قال النبي ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه» (رواه البخاري).
ثالثًا: التنبيه على خطورة التكفير
- التكفير ليس لكل أحد، بل هو من اختصاص العلماء والقضاة، لأنه حكم خطير يترتب عليه آثار شرعية في الدنيا والآخرة.
قال النبي ﷺ: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما» (متفق عليه).
عقوبة الكفر في الاسلام
1. العقوبة في الآخرة
- الكفر أعظم الذنوب وأكبر الجرائم في ميزان الشرع.
- من مات على الكفر مخلّد في نار جهنم ولا يُغفر له. قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ [البينة: 6]
- لا تنفع الكافر أعماله الصالحة إذا مات على كفره، قال تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان: 23]
2. العقوبة في الدنيا
- من وقع في الكفر بعد الإسلام (الردة) وأقيمت عليه الحجة الشرعية وتحققت الشروط وانتفت الموانع، فإنه:
- يُدعى للتوبة ويُمهل ثلاثة أيام (عند كثير من الفقهاء).
- إذا تاب قبلت توبته.
- إذا أصرّ، يقام عليه حد الردة وهو القتل، لقول النبي ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه» (رواه البخاري).
- هذه العقوبة يختص بتنفيذها ولي الأمر أو القضاء الشرعي، وليست فردية.
الكفر الأصلي (أي من لم يدخل الإسلام أصلًا) لا يُعاقب صاحبه في الدنيا على مجرد عقيدته، إلا إذا حارب المسلمين أو اعتدى، والإسلام يحث على الدعوة بالحكمة قبل إقامة أي عقوبة.
حد الكفر في الاسلام
- لا يوجد في الفقه الإسلامي ما يسمى "حد الكفر" كمصطلح مستقل، لكن المقصود به عند العلماء غالبًا هو حكم المرتد، أي المسلم الذي يخرج من الإسلام بكلمة أو فعل أو اعتقاد بعد دخوله فيه.
- أما الكافر الأصلي (الذي لم يدخل الإسلام من قبل) فلا يقام عليه "حد" لمجرد كفره، وإنما يُدعى إلى الإسلام، فإن رفض يعيش في ظل الدولة الإسلامية وفق أحكام أهل الذمة أو يُقاتل إذا كان محاربًا.
حكم المرتد (حد الردة)
إذا ثبت على شخص أنه ارتد عن الإسلام:
- يُستتاب (يُدعى للتوبة) مدة يراها الحاكم أو القاضي مناسبة، وغالبًا ثلاثة أيام عند كثير من الفقهاء.
- إذا تاب وعاد إلى الإسلام، تُقبل توبته.
- إذا أصرّ على الكفر بعد إقامة الحجة وانتفاء الموانع، يُحكم عليه بالقتل.
- الدليل: قول النبي ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه» (رواه البخاري).
من هم الكفار الذين يدخلون الجنة ؟
- في العقيدة الإسلامية، الأصل أن من مات على الكفر بعد بلوغ الدعوة وقيام الحجة عليه لا يدخل الجنة أبدًا، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ﴾ [المائدة: 72]
- لكن العلماء ذكروا استثناءات ليست بمعنى أن الكافر الأصلي يدخل الجنة مع علمه بالحق، بل هي حالات لا يُحكم على صاحبها بالكفر الموجب للخلود في النار بسبب عدم قيام الحجة أو العذر الشرعي.
الفئات التي قد تُعذر ولا تُعاقب في الآخرة
«أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئًا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة. فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئًا، وأما الأحمق فيقول: رب جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر، وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئًا، وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول. فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، فيرسل إليهم أن ادخلوا النار، قال: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها كانت عليهم بردًا وسلامًا»
- أهل الفترة: هم الذين عاشوا بين فترة نبيين ولم تصلهم رسالة التوحيد صحيحة، واختلف العلماء: بعضهم قال يُختبرون يوم القيامة، وبعضهم قال يُعذرون.
- من لم تبلغه الدعوة أبدًا: مثل من عاش في مناطق نائية أو أزمان انقطعت فيها الرسالات، والحكم فيهم لله، وكثير من العلماء قال إنهم يُمتحنون يوم القيامة.
- المجنون أو فاقد العقل طوال حياته: لا تكليف عليه، ولا يُحاسب كالكفار المكلفين.
- الصغير الذي مات قبل البلوغ: ولو كان ابن كافرين، فالله أعلم بمصيره، وأكثر الأقوال أن مصيرهم إلى رحمة الله.
- من كان عنده جهل لا يمكنه دفعه: أي جهل معذور بسبب بيئة أو ظروف تمنع وصول العلم الصحيح.
للإستفادة من هذا المقال انسخ الرابط
https://mafahem.com/sl_21456