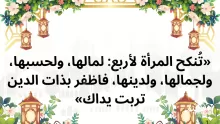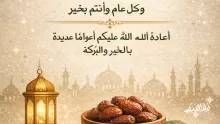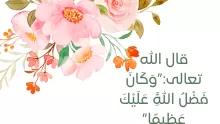ما الفرق بين الحسب والنسب؟

ما الفرق بين الحسب والنسب؟
الفرق بين الحَسَب و النَّسَب كما يورده أهل اللغة والعلماء:
1. الحَسَب
- هو ما يَحصُل عليه الإنسان من مكارم الأخلاق، والفضائل، والأفعال المحمودة التي يشتهر بها هو أو أهله.
- أي أنه يتعلق بما يَكتسبه المرء أو يُعرف به أهله من الصفات والسيرة الحسنة.
- مثال: يُقال "فلان ذو حسب" أي ذو مروءة، كرم، شجاعة، علم، أو مكانة اجتماعية معتبرة.
- الأهمية: يعكس شرف الأسرة، ومستوى تقبلها في المجتمع، وقدرتها على تكوين علاقات اجتماعية ناجحة.
2. النَّسَب
- هو الانتماء العائلي أو القبلي الممتد عبر الآباء والأجداد.
- أي أنه شيء يُورَث ولا يكتسب، مثل الانتماء إلى قبيلة معينة أو عائلة ذات أصل معروف.
- مثال: يُقال "فلان شريف النسب" أي من نسل معروف أو عائلة عريقة.
- الأهمية: يحدد الأصول الأسرية ويؤثر على العلاقات الأسرية، خاصة عند الزواج لضمان تواصل الأسرة واستمراريتها.
الحسب يتعلق بالسمعة والمكانة الاجتماعية، أما النسب فيتعلق بالأصول والقرابة. يمكن أن تكون الأسرة ذات نسب عريق ولكن حسب ضعيف، أو العكس، وكل حالة لها تأثيرها الاجتماعي المختلف
معنى حسب ونسب
المعنى اللغوي
- الحَسَب لغةً: من مادة (حَسَبَ) أي العدّ. والحسب هو ما يعدّه الإنسان من مفاخر آبائه وأجداده من كرمٍ أو شرفٍ أو مآثر. ويُقال: فلان له حسب، أي له شرف أو كرامة بين الناس بما ورثه من أهله.
- النَّسَب لغةً: من مادة (نَسَبَ) أي الانتساب والقرابة. والنسب هو اتصال الشخص بآبائه وأجداده عن طريق الولادة، فيُقال: فلان نسبه إلى قبيلة كذا أو بيت كذا.
المعنى الاصطلاحي
- الحَسَب اصطلاحًا: ما يتحلى به الإنسان من الفضائل والمكارم، سواء اكتسبها بنفسه أو ورثها من سلفه. أي هو ما يُمدح به المرء من أخلاق أو أفعال أو مكانة اجتماعية.
- النَّسَب اصطلاحًا: هو القرابة الممتدة بين الأفراد من جهة الأب غالبًا، أو رابطة الدم التي تجمع الإنسان بعشيرته وقبيلته وأسرته، ويُستدل به على الأصل والعشيرة.
مثال: قد يكون الرجل شريف النسب (من بيت معروف بالأصالة) ولكنه بلا حسب (أي لم يكتسب مآثر أو مكارم). والعكس صحيح: قد يكون إنسان عادي النسب لكنه صاحب خلق وعلم وكرم فيُمدح حسبًا.
الحسب والنسب في القرآن
الحسب والنسب ورد معناهما في القرآن الكريم لكن ليس بلفظهما مجتمعين، وإنما في إشارات ومعانٍ متفرقة، تبين أن الكرامة عند الله لا تقوم على الحسب ولا النسب، وإنما على الإيمان والعمل الصالح.
1. الحسب في القرآن
الحسب يأتي بمعنى الكفاية أو الظن أو ما يُعدّ من مكارم:
- قال تعالى: ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [النساء: 6] → أي كافيًا محاسبًا لعباده.
- وقال: ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ [العنكبوت: 2] → أي أظنّ الناس.
- وقال: ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: 46]. فهنا الحسب ليس بمعنى الحسب الاجتماعي، وإنما بمعنى الكفاية أو الاعتقاد.
2. النسب في القرآن
وردت الإشارة للنسب في سياق أنه لا ينفع صاحبه يوم القيامة:
- قال تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءلُونَ﴾ [المؤمنون: 101].
- وقال: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: 13] → نفي لاعتبار النسب وحده معيارًا للكرامة.
الخلاصة: الحسب في القرآن جاء بمعاني الكفاية، والاعتقاد، والكرامة المعنوية، والنسب في القرآن ورد في نفي فائدته يوم القيامة، والتأكيد أن التفاضل ليس به، بل بالتقوى. أي أن القرآن قرر أن الحسب والنسب لا يرفعان الإنسان عند الله إلا إذا اقترنا بالتقوى والعمل الصالح.
الحسب والنسب في الزواج
الحسب والنسب من المعايير التي كان يُنظر إليها في الزواج عند العرب قديمًا، ولا تزال موجودة بنسب متفاوتة في بعض المجتمعات، لكن الشريعة الإسلامية وضعت الميزان الصأح.
1. الحسب والنسب عند العرب في الزواج
- الحسب: كان يُراد به شرف الرجل بنفسه وأفعاله وكرمه ومكانته الاجتماعية.
- النسب: هو أصل العائلة والقبيلة وما اشتهرت به من مكانة وشرف.
- وكانوا يرون أن الزواج لا بد أن يكون بين الأكفاء في الحسب والنسب.
2. الحسب والنسب في الزواج في الإسلام
- الإسلام لم يلغِ الاعتبار بالنسب والحسب، لكن جعلهما ثانويين أمام معيار الدين والخلق.
- قال ﷺ: «تُنكَح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك» (رواه البخاري ومسلم).
- وقال ﷺ: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» (رواه الترمذي).
إذن: الحسب والنسب معتبران ولكن ليسا الأساس. الأساس هو الدين والخلق، لأنهما سبب الاستقرار والبركة في الزواج.
معنى الحسب والنَّسَبِ في الحديث
ورد ذكر الحسب والنَّسب في عدد من الأحاديث النبوية، وغالبًا في سياق بيان معايير اختيار الزوجة أو الزوج، وبيان قيمة الدين مقارنة بالحسب والنسب.
- الحسب: يقصد به في الأحاديث ما للرجل أو المرأة من مكانة وشرف بين الناس، سواءً بسبب المال، أو الجاه، أو الكرم، أو غير ذلك من الخصال التي يُمدح بها المرء. قال ابن الأثير في النهاية: الحسب ما يعدّه الإنسان من مفاخر آبائه وما يفتخر به من مآثرهم.
- النسب: هو الانتساب إلى الآباء والأجداد، أي أصل الإنسان وعائلته وشجرته العائلية، وما يُعرف به من قبيلة أو بيت أو عشيرة.
حديث: أربع من أمتي من أمر الجاهلية
عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنيحة». — صحيح مسلم وغيره
شرح الحديث:
- الفخر في الأحساب: أي التفاخر بالأسرة والمكانة الاجتماعية والاعتداد بها، وهي عادة من عادات الجاهلية التي كانت تركز على الحسب دون النظر للأخلاق والدين.
- الطعن في الأنساب: أي السب والشتم بانتساب العائلات أو الأنساب، وهو عمل مذموم لأنه يهين الناس على أساس أصلهم وليس أفعالهم.
- الاستسقاء بالنجوم: كان الجاهليون يعتمدون على النجوم في طلب المطر والتقويم، وهذا شرك بالله، وقد حذر الإسلام منه.
- النيحة: أي البكاء والصراخ على الموتى بطريقة مبالغ فيها، وهي عادة من الجاهلية لم يُشجع عليها الإسلام.
- الحكمة من الحديث: الحديث يحذر من التعلق بالمظاهر الاجتماعية والأنساب بطريقة مفرطة، ويشدد على أهمية الاعتداد بالقيم الدينية والأخلاقية بدل الفخر بالحسب أو الهجوم على النسب.
حديث تنكح المرأة لأربع ماهو الحسب؟
- حديث الصحيحين: قال النبي ﷺ: «تُنكَحُ المرأةُ لأربع: لمالِها، ولحسبِها، ولجمالِها، ولدينِها، فاظفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يداكَ». (رواه البخاري ومسلم)
- هنا الحسب: الشرف والجاه والمكانة الاجتماعية، والنسب: داخل في معنى الحسب لكنه أدق، إذ يتعلق بأصل العائلة وشرفها.
حديث الرسول عن النسب والاصل
وردت عن النبي ﷺ أحاديث كثيرة تتعلق بالنَّسب والأصل، وهنا بعض أهمها مع معناها:
1. حديث "ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه"
قال النبي ﷺ:
«ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه» [رواه مسلم (2699)]
المعنى: لا ينفع الإنسان شرف نسبه وأصله إذا قصَّر في عمله الصالح، فالعبرة بالتقوى والعمل لا بالحسب والنسب.
2. حديث "تعلموا من أنسابكم"
قال النبي ﷺ:
«تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر» [رواه الترمذي (1979) وأحمد]
المعنى: معرفة النسب مطلوبة لا للفخر، وإنما لتقوية صلة الرحم والبرّ والإحسان.
3. حديث "لا فضل لعربي على أعجمي"
قال النبي ﷺ في خطبة الوداع:
«يا أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى»[رواه أحمد (23489)]
المعنى: النسب لا يرفع الإنسان عند الله، بل المعيار هو التقوى والعمل الصالح.
حديث ولا تخالطوا بالانساب
ردت أحاديث صحيحة كثيرة عن تحريم خلط الأنساب ووجوب حفظها، لما فيها من خطورة على الدين والمجتمع والمواريث وأحكام الشرع، ومن الأحاديث:
- قال النبي ﷺ:«مَنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيهِ وهو يعلَمُ أنَّه غيرُ أبيهِ، فالجَنَّةُ عليه حرامٌ» (رواه البخاري 4326، ومسلم 63).
- وقال ﷺ: «ليسَ من رجلٍ ادَّعى لغيرِ أبيه وهو يَعلَمه إلا كَفَر، ومَنِ ادَّعى ما ليس له فليس مِنَّا، ولْيتبوَّأ مقعدَه من النَّار» (رواه البخاري 3508، ومسلم 61).
- وقال ﷺ: «أيُّما امرأةٍ أدخلت على قومٍ ما ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين» (رواه أبو داود 2263، والنسائي 3493، وصححه الألباني).
المعنى:
- خلط الأنساب من الكبائر.
- يدخل فيه: انتساب شخص لغير أبيه، أو نسبة ولد إلى غير أبيه الحقيقي، أو إنكار الرجل ولده.
- الحكمة: لحماية المجتمع من الفوضى الأخلاقية والظلم في الميراث والاختلاط في المحارم.
معنى ولا تخالطوا بالانساب
العبارة "ولا تُخالِطوا بالأنساب" جاءت في وصايا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وليست حديثًا مرفوعًا إلى النبي ﷺ.
المعنى:
- المقصود ألا يُدخِل الناسُ في أنسابهم ما ليس منها، أو يخلطوا أنسابهم بالادعاء الباطل، كأن ينتسب المرء إلى غير أبيه، أو إلى قبيلة ليست له، أو يغيّر نسبه طلبًا للشرف أو دفعًا للعار. فالأنساب لها مكانة في الإسلام، لحفظ الحقوق والميراث والعِرض، لذلك نهى عمر رضي الله عنه عن خلطها، وحذّر من ضياعها.
من أقوال العلماء:
- قال ابن حجر: المخالطة في الأنساب تعني إدخال مَن ليس من القوم فيهم، أو نسبة المرء إلى غير أبيه، وهذا من الكبائر لما ورد فيه من اللعن في السنة.
- وفي الحديث الصحيح: «مَنِ ادَّعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام» (رواه البخاري ومسلم).
حديث شريف عن تكافؤ النسب
رد في تكافؤ النسب في الزواج بعض الأحاديث، ومن أبرزها ما رواه النبي ﷺ، وإن كان العلماء قد اختلفوا في درجة بعضها:
- قال رسول الله ﷺ: «تَخَيَّروا لنطفكم، وانكحوا الأكفاء، وأنكحوا إليهم» — رواه ابن ماجه (رقم 1968) والبيهقي، وقال عنه بعض المحدثين: في إسناده ضعف، لكن معناه معمول به عند كثير من الفقهاء.
- وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائكًا أو حجامًا» — أخرجه الطبراني في الأوسط، وقال الألباني: ضعيف جدًا.
الأحاديث الواردة في تكافؤ النسب أكثرها ضعيف، ولكن الفقهاء استدلوا بها وبعمل الصحابة على اعتبار الكفاءة في النسب (خاصة قريش) عند بعض المذاهب. وقد يرى جمهور العلماء أن الأصل في الكفاءة هو الدين والخلق، كما قال ﷺ: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوِّجوه» (رواه الترمذي وحسنه).
الفرق بين الحسب والنسب عند الشيعة
الشيعة – مثل جمهور المسلمين – يفرّقون بين الحَسَب و النَّسَب، مع بقاء المعنى العام قريباً من الاستعمال العربي والإسلامي الشائع، لكن مع بعض التأكيدات الخاصة عندهم.
النَّسَب عند الشيعة
- هو القرابة بالولادة والدم، أي الانتماء إلى أبٍ وأصلٍ معين، مثل الانتساب إلى قبيلة، أو إلى آل البيت (عليهم السلام).
- النسب ثابت لا يتغيّر، ويُعتبر شرفاً إذا كان إلى أصول طيبة أو إلى رسول الله ﷺ وآله.
- عند الشيعة مكانة خاصة للنسب النبوي، حيث يرون أنّ الانتساب إلى النبي ﷺ وأهل بيته شرف عظيم يزيد في فضل صاحبه إذا كان متقياً عاملاً.
الحَسَب عند الشيعة
- هو ما يُكتَسب من الفضائل بالدين، والتقوى، والأخلاق، والمكارم، وليس بمجرد الولادة.
- الحسب يُكسبه الإنسان بنفسه عن طريق أفعاله وسيرته، سواء كان من نسب رفيع أو لا.
- ورد عن الإمام عليّ (عليه السلام): «الحَسَبُ المالُ، والكَرَمُ التَّقوى» (نهج البلاغة، الحكمة 371).
الفرق بينهما باختصار
- النسب: الأصل والقرابة والولادة (من أين أتيت؟).
- الحسب: ما تحمله من أخلاق وفضائل ومكارم (من أنت في نفسك؟).
وبذلك، فإن الشيعة يؤكدون أنّ النسب وحده لا ينفع بلا عمل وتقوى، مستندين لقول النبي ﷺ:
«من بطّأ به عملُه لم يسرع به نسبُه».
أهمية الحسب والنسب في الزواج
أهمية الحسب والنسب في الزواج تعتبر من المفاهيم الاجتماعية والثقافية التي اهتم بها العرب منذ القدم، ولها مكانة كبيرة في تقليد وتقاليد الزواج. يمكن تلخيص أهميتها فيما يلي:
- تكافؤ الأسر والمستوى الاجتماعي: الحسب يشير إلى المكانة الاجتماعية للأسرة وسمعتها، والنسب يدل على أصول العائلة وامتدادها. اختيار شريك حياة من أسرة ذات حسب ونسب متقارب يساعد على تجنب صراع الطبقات أو الفجوة الاجتماعية.
- ضمان الاستقرار الأسري: عندما يكون الزوجان متقاربان في النسب والحسب، غالبًا ما يكون هناك تفاهم وتقبل متبادل بين العائلتين، مما يقلل النزاعات ويعزز الاستقرار الأسري.
- الاعتبارات الدينية والأخلاقية: في بعض المجتمعات، يُنظر إلى الزواج بين الأسر المتقاربة في النسب والحسب على أنه يتفق مع التعاليم الدينية التي تشجع على اختيار الشريك الصالح والمناسب اجتماعياً وأخلاقياً.
- حماية السمعة والشرف: النسب والحسب الجيد يساعد على الحفاظ على سمعة الأسرة والشريك، حيث يعتبر الزواج من أسرة محترمة دليلاً على التزام القيم والعادات.
- تسهيل العلاقات الاجتماعية المستقبلية: الزواج بين أسر متقاربة في الحسب والنسب يسهل التواصل الاجتماعي والعلاقات بين العائلتين، مما يعزز الدعم الاجتماعي للأطفال والأسرة بشكل عام.
للإستفادة من هذا المقال انسخ الرابط
https://mafahem.com/sl_21494